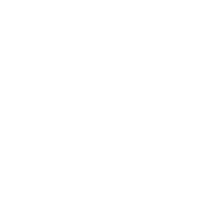ما بين خطاب التمكين وواقع الهشاشة: تحليل جندري لتجارب النساء والرجال في سوق العمل السعودي في ظل الدولة الأبوية.
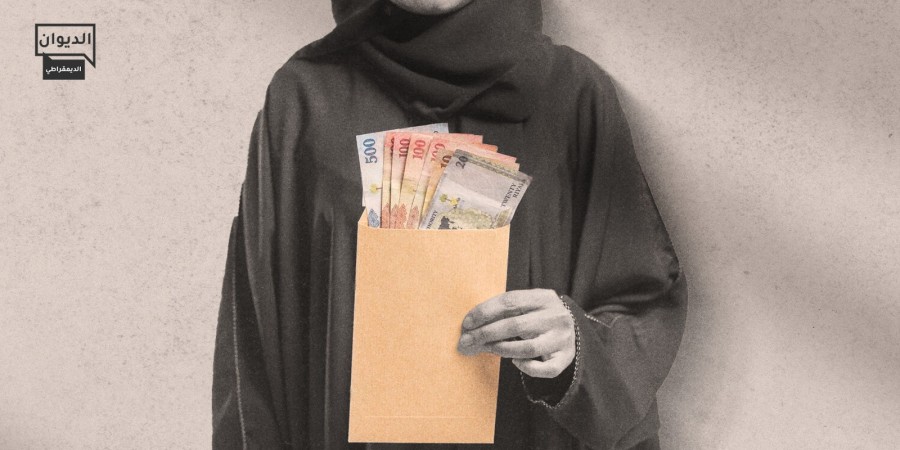
المؤلفة: د.مريم الدوسري
رويال هولواي، جامعة لندن.
سارة شودري
نشرت هذه الورقة في فبراير 2024
الخلاصة:
تتناول هذه الدراسة التداخل بين السياسات التي تقودها الدولة، وأشكال الهشاشة المرتبطة بالنوع الاجتماعي في قطاع التجزئة بالسعودية، بالاعتماد على ست وعشرين مقابلة معمقة مع موظفين وأطراف معنية أخرى. وتسعى الدراسة إلى تقديم تصور متكامل لطبيعة الهشاشة المركبة، مبرزةً دور الدولة والثقافة الأبوية في تكريس عدم المساواة بين الجنسين، وصياغة التجارب الفردية في ظل ظروف الهيمنة البنيوية.
فعلى صعيد الرجال السعوديين، أفضت السياسات الحكومية إلى زيادة حالة انعدام الأمن الوظيفي، وإلى تقويض النموذج الأسري التقليدي القائم على دور الرجل كمعيل. في المقابل، واجهت النساء السعوديات أشكالًا متداخلة من الضعف الاجتماعي والاقتصادي، مقرونةً بضعف الدعم المؤسسي، الأمر الذي انعكس في محدودية التبليغ عن وقائع التحرش الجنسي، وقلة أشكال الاحتجاج ضدها.
إن هذا التفاعل المتوتر بين السياسات الرسمية والمعايير الاجتماعية الراسخة يفرز هشاشة مزدوجة: بنيوية (هيكلية) وذاتية، في بيئة العمل. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في الكشف عن تعقيدات معالجة الفجوة بين الجنسين، عبر تتبع تقاطع النوع الاجتماعي مع الديناميكيات الدينية وبُنى السلطة. كما تسهم في إثراء فهم التحولات المرتبطة بالنوع الاجتماعي في السعودية، من خلال توضيح كيفية إسهام الدولة والثقافة الأبوية معًا في إنتاج أشكال متعددة من الهشاشة. وتخلص الدراسة إلى ضرورة ترسيخ الوعي النسوي لدى النساء بوصفه جزءًا من استراتيجية أوسع لمواجهة اختلالات المساواة بين الجنسين.
مقدمة:
في السعودية، تتشكل تجارب النساء في سوق العمل بفعل التفاوت المستمر بين الجنسين، وتغلغل المعايير الأبوية، إلى جانب الإرث التاريخي لسياسات الفصل بين الجنسين التي تبنتها الدولة. ويعكس ذلك التداخل بين المبادرات الحكومية من جهة، والتأثير العميق للثقافة الأبوية على المجتمع من جهة أخرى. ومنذ عام 2016، شرعت الحكومة في تنفيذ أجندة حداثية واسعة النطاق ركزت بصورة لافتة على تمكين المرأة، محددة أهدافًا من أبرزها رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 30% بحلول عام 2030. كما أولت برامج التوطين (السعودة) اهتمامًا ببُعد النوع الاجتماعي، وجرى تطبيق مبادرات التأنيث لدعم اندماج النساء بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الإصلاحات الرسمية الهادفة إلى تعزيز حضور المرأة في سوق العمل، فإن بطء تحولات المعايير الاجتماعية – المتأثرة بالثقافة القبلية المحافظة والتفسيرات الأبوية للدين – يُبقي تجارب النساء في بيئة العمل محاطة بالهشاشة وعدم الاستقرار.
ورغم كثرة الدراسات التي تناولت دور "الدولة الأبوية" في تكريس التفاوت بين الجنسين، فإن الأبحاث التي تدرس إسهامهما المباشر في تشكيل هشاشة العمل أو هشاشة النوع الاجتماعي داخل أماكن العمل ما زالت محدودة. فعلى الرغم من أن الأدبيات تربط انتشار بيئة العمل غير المستقرة بعوامل متعددة، مثل دور الدولة، والعولمة، وصعود اقتصاد العمل الحر، والتطور التكنولوجي، إلا أن البعد الخاص بتأثير الدولة والثقافة الأبوية لم ينل ما يستحقه من دراسة معمقة.
غالبًا ما يُنظر إلى الهشاشة بوصفها حالة مرتبطة بالعمل، وتُختزل أحيانًا في كونها تجربة ذاتية قائمة على "الإحساس بعدم الاستقرار". غير أن هذه الورقة تسعى إلى تجاوز هذا التصور الضيق من خلال دراسة التداخل بين الهشاشة الموضوعية (المرتبطة بالبنية والسياسات) والهشاشة الذاتية (المعاشة فرديًا)، باعتبار أن البعدين مترابطان ومتكاملان.
وعليه، فإن هدفنا البحثي يتمثل في تحليل التفاعل بين الديناميكيات الأبوية والثقافية من جهة، والسياسات الحكومية من جهة أخرى، لفهم كيفية تشكّل التجربة المعيشة للهشاشة في أبعادها المختلفة. وانطلاقًا من بحث ميداني أجريناه في قطاع التجزئة السعودي، نسعى للإجابة عن السؤال المركزي الآتي: كيف يؤثر التفاعل بين المبادرات الرسمية والمعايير الاجتماعية والدينية والثقافية في صياغة التجربة المعاشة للهشاشة، سواء في أبعادها البنيوية أم الذاتية؟
تسهم دراستنا في توسيع فهم العمالة غير المستقرة عبر تحليل التداخل المعقد بين الهشاشة الموضوعية والهشاشة الذاتية، مع التركيز على دور الدولة والمعايير المجتمعية. وبالاستناد إلى نظرية الأبوية لوالبي، نقدم رؤى جديدة حول العلاقة المتشابكة بين الثقافة الأبوية والدولة، مبرزين دورهما في إعادة إنتاج عدم المساواة بين الجنسين. ويتيح لنا هذا المنظور فحص الكيفية التي تُشكّل بها الهياكل الأبوية المتداخلة تجارب الهشاشة القائمة على النوع الاجتماعي. والأهم من ذلك، أننا نوسع نطاق تصور والبي من خلال استكشاف التفاعل بين المعايير الدينية والهياكل الأبوية في السعودية، مع إبراز العوامل الاجتماعية والتفسيرات الدينية التي تُسهم في ترسيخ التفوق الذكوري.
وفي الأجزاء التالية من الورقة، سنعرض مراجعة شاملة للأدبيات المتعلقة بالهشاشة والممارسات المؤسسية المبنية على النوع الاجتماعي، ثم نوجز منهجية البحث، ونقدّم تحليلًا معمقًا للنتائج التجريبية المستخلصة من قطاع التجزئة السعودي. وفي الختام، سنناقش التداعيات النظرية المترتبة على هذه النتائج.
العمالة غير المستقرة
ظهر مفهوما "الهشاشة" و"العمل الهش" في سبعينيات القرن الماضي، في سياق الحركات العمالية والاجتماعية الأوروبية، لوصف أنماط العمل المرن والعرضي وغير المنتظم (لوري، 2015). ومنذ ذلك الحين، ظل مفهوم الهشاشة موضع جدل أكاديمي مستمر. فبينما ينظر بعض الباحثين إليها كحالة عمالية موضوعية، يعرّفها آخرون باعتبارها تجربة ذاتية قوامها الإحساس بعدم الاستقرار.
ويُركز المنظور الأول على سمات العمل غير المستقر، مثل انعدام الأمان الوظيفي، وانتشار العقود المؤقتة أو الجزئية، وضعف المزايا الاجتماعية، وانخفاض الدخل، حيث يصبح العمل "غير مؤكد، وغير متوقع، ومحفوفًا بالمخاطر". ويرتبط هذا النمط من التوظيف بالتحولات التي يشهدها سوق العمل تحت تأثير توسع الرأسمالية، وانتشار أنماط العمل العرضي، وصعود السياسات النيوليبرالية في اقتصاد متزايد العولمة، الأمر الذي أفضى إلى انعدام الأمن المالي، وتراجع شبكات الأمان الاجتماعي، والتطبيع التدريجي مع أنماط العمل غير النظامية.
ورغم الاعتراف الواسع بالأسس الهيكلية للهشاشة، فقد وُجّه النقد إلى هذا الاتجاه البحثي لاقتصاره غالبًا على المعالجة الموضوعية للهشاشة، مما أهمل العديد من الأبعاد الدقيقة. فعلى سبيل المثال، لا يأخذ تعريف الهشاشة باعتبارها مجرد "عمل مؤقت أو عرضي" في الحسبان الفروق الجوهرية بين أثر هذه الأنماط على المهن منخفضة الأجر (مثل عمال النظافة أو السائقين) مقارنة بالمهن عالية الأجر (مثل خبراء تكنولوجيا المعلومات أو الاستشاريين المستقلين). وبالمثل، فإن حصر الهشاشة في نطاق العمل غير الرسمي أو غير القياسي يغفل أنماط عمل جديدة قد لا تقل هشاشة، بل ويتجاهل وجود هشاشة كامنة حتى في الأشكال "الرسمية" والقياسية للعمل.
في إطار توسيع نطاق التصورات البنيوية للهشاشة، اتجه بعض الباحثين إلى استكشاف أبعادها الذاتية، باعتبارها شعورًا يتجسد في الإحساس بفقدان الاعتراف الاجتماعي وضعف الاندماج في المجتمع. ويُستعان في مواجهة هذا النوع من الهشاشة بروابط القرابة والدعم الاجتماعي، فضلًا عن سياسات دولة الرفاه، بوصفها آليات وقائية تحد من حدّتها. ويُقدَّم هذا المنظور البديل للهشاشة باعتبارها "حالة اجتماعية-اقتصادية وتجربة وجودية"، تُبرز التداخل بين "العمل غير المستقر والحياة غير المستقرة".
فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة أليسون حول الشباب الياباني أن البطالة أفضت إلى هشاشة بنيوية على مستوى الاقتصاد وسوق العمل، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن أشكال أوسع من الهشاشة تتجلى في تآكل الروابط الاجتماعية، وتراجع شعور الأفراد بالترابط مع الآخرين وبالأمان.
وفي هذا السياق، تهدف دراستنا إلى الإسهام في الأدبيات المعنية بالهشاشة عبر الجمع بين تحليل الظروف البنيوية وظروف العمل من جهة، والتجارب الذاتية والمعيشية من جهة أخرى. إذ نسعى إلى فهم التفاعل بين الهشاشة الموضوعية والذاتية، مع التأكيد على أن كلا البعدين مترابط ومتكامل. ونرى أن مقاربة شاملة لتجربة الأفراد مع الهشاشة تتطلب النظر في السياق الاجتماعي الأوسع، إذ يرتبط إدراك الأفراد للهشاشة ودرجة معايشتهم لها ارتباطًا وثيقًا ببيئتهم المعيشية العامة.
ومن ثم، فإن الفجوة البحثية التي تسعى هذه الورقة إلى معالجتها تكمن في فهم كيفية تفاعل السياسات الحكومية والتنظيمية مع البنى الأبوية والقيم الدينية في المجتمع السعودي. ونؤكد أن تحليل هذا التفاعل المعقد بين الدولة والمؤسسات والمعايير الاجتماعية يُعد مدخلًا جوهريًا لفهم انعكاسات الهشاشة على المستوى الفردي.
تُبرز الأدبيات الراهنة أهمية إدراك السياق التاريخي والاجتماعي الأوسع لسوق العمل والاقتصاد لفهم معنى الهشاشة داخل إطار وطني محدد. ففي الاقتصادات المتقدمة، غالبًا ما يُعزى عدم الاستقرار الوظيفي إلى التحولات الهيكلية الكبرى في سوق العمل مقرونةً بغياب تدخل الدولة. أما في الاقتصادات النامية، فيرتبط ذلك عادةً بندرة الموارد الاقتصادية والسياسية على مستوى الدولة. وفي هذا الإطار، تُمثل السعودية حالة مغايرة لافتة، إذ تجمع بين تدخلات حكومية تستهدف تقليص أوجه عدم المساواة في سوق العمل عبر سياسات التحديث والانفتاح، وبين غياب الإرادة الاجتماعية والقدرات المؤسسية والفردية الكافية لتحقيق هذه الأهداف بصورة فعّالة.
إلا أن الأدبيات الحالية حول الهشاشة كثيرًا ما تغفل التفاعل المعقد بين التجارب الذاتية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعوامل البنيوية الأوسع نطاقًا، خصوصًا في السياقات التي تتقاطع فيها السياسات الأبوية للدولة مع المعايير الثقافية والاجتماعية. ومن هنا تأتي مساهمة دراستنا التي تسعى إلى استكشاف الكيفية التي يدرك بها الرجال والنساء على السواء الأثر المتشابك للعوامل الاجتماعية والهيكلية والتنظيمية في تشكيل تجاربهم المعيشية للهشاشة، وكيفية تعاملهم معها أو مقاومتها. وتُتيح هذه المقاربة المراعية للفوارق الجندرية فهمًا أكثر شمولًا للهشاشة، يدمج بين أبعادها الذاتية وتجلياتها البنيوية.
الممارسات المؤسسية الجندرية والتمييز على أساس النوع الاجتماعي
تسهم المعايير الاجتماعية الراسخة، إلى جانب البُنى التنظيمية التي يهيمن عليها الذكور، في تكريس أوجه عدم المساواة بين الجنسين داخل سوق العمل. وتؤدي هذه الأنماط إلى إنتاج بيئات عمل ذات طابع ذكوري، وإلى تركز النساء في أشكال العمل الهش وغير الرسمي، فضلًا عن الفجوات في الأجور، والفصل المهني بين الجنسين. كما تتفاقم هذه الاختلالات بفعل التوقعات التقليدية المرتبطة بأدوار المرأة داخل الأسرة، والتقسيم غير المتوازن للعمل المنزلي، وما يترتب عليه من تحميل النساء أعباءً أكبر في مجال الرعاية. ويُعد هذا التقسيم الجندري للأدوار عاملًا محوريًا في فهم العمالة غير المستقرة، إذ لا يدفع النساء نحو وظائف منخفضة الأجر وحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إضعاف الأجور وشروط العمل في المهن التي تتركز فيها النساء.
وقد أنتجت الأبحاث حول النوع الاجتماعي والعمل غير المستقر تيارين أساسيين من الأدبيات. يرتكز الأول على إحصاءات سوق العمل، ولا سيما بيانات العمالة الناقصة والبطالة، لتعريف الهشاشة الجندرية. ورغم ما يقدمه هذا التوجه من معطيات قيّمة، فإنه يظل محكومًا بالمنظور البنيوي/الموضوعي للهشاشة، مما يجعله قاصرًا عن استيعاب التعقيدات الجندرية والتجارب الذاتية المتباينة للرجال والنساء في سوق العمل. أما التيار الثاني فيركز على الكيفية التي يؤثر بها التفاعل بين تقسيم العمل المنزلي التقليدي والممارسات التنظيمية في دفع النساء إلى العمل غير المستقر. فعلى سبيل المثال، أدى تهميش النساء في الوظائف غير القياسية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية (2008–2009)، أو حصر الأكاديميات في مهام أقل قيمة وأدنى أجر مع استبعادهن من مناصب صنع القرار، إلى تعزيز أوجه عدم المساواة الجندرية وتكريس مكانة النساء الهشة في سوق العمل.
وتهدف ورقتنا إلى الإسهام في كلا المسارين البحثيين من خلال دراسة الآثار المترتبة على الممارسات المؤسسية الجندرية والمعايير الاجتماعية والثقافة الأبوية للدولة على التجارب الذاتية والمعيشية للهشاشة. وتتقاطع هذه المقاربة مع منظور أرمسترونغ وريدجواي، اللذين شدّدا على أهمية إعادة الإنتاج التنظيمي للمعايير الاجتماعية-المؤسسية لفهم أعمق للهشاشة الجندرية.
أظهرت الدراسات السابقة أن المجتمعات الأبوية تُنتج ترتيبات اجتماعية ومؤسسية خاصة تُكرّس أوجه عدم المساواة بين الجنسين، مثل تأنيث بعض المهن، وحصر النساء في وظائف لا تتبع المعايير الرسمية أو التقليدية للعمل المستقر أو حت استغلالية، واستمرار الأعباء غير المدفوعة للأعمال المنزلية والرعائية. وفي هذا السياق، يوفّر إطار والبي حول "الدولة الأبوية" و"الثقافة الأبوية" منظورًا تحليليًا شاملًا لفهم المؤسسات والآليات التي تُعيد إنتاج التفاوتات الجندرية داخل المجتمع.
يركز مفهوم الدولة الأبوية على الكيفية التي تُترجم بها القيم والمعايير الأبوية إلى مؤسسات وسياسات تُبقي النساء في موقع التبعية، بينما تعمل الثقافة الأبوية على ترسيخ هذه التفاوتات من خلال الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية والمعتقدات الراسخة. ورغم وفرة الأدبيات التي تناولت دور الدولة والثقافة الأبوية في تعزيز اللامساواة الجندرية، فإن تأثيرها المباشر على الهشاشة الجندرية في العمل لم يُدرس بعد بالقدر الكافي.
وانطلاقًا من طرح والبي، تؤكد هذه الورقة على الدور المحوري للدولة والمعايير الثقافية في تكوين أشكال الهشاشة، سواء عبر إعادة إنتاج الفوارق الجندرية أو من خلال تشكيل التجارب الذاتية للأفراد في سوق العمل. كما نشدد على ضرورة الانتباه إلى التباينات الجوهرية بين تجارب الهشاشة في السياقات الغربية والصناعية من جهة، والمجتمعات التقليدية والأبوية من جهة أخرى. ومن هنا، ندعو إلى مقاربة نقدية أعمق للهشاشة عبر دراسة تقاطع المعتقدات الاجتماعية والدينية، والنماذج الأسرية، والأنماط الأوسع لعدم المساواة بين الجنسين، ضمن الأطر المؤسسية التي تُنشئها الدولة وتُعيد إنتاجها.
سياق الدراسة: السعودية
في السعودية، تُقيّد الدولة الأبوية – بما تحمله من خصائص الملكية المطلقة، وهو ما ينعكس في ارتفاع معدلات البطالة بين النساء السعوديات (30.2%) مقارنةً بالمجتمعات الغربية. وقد جاءت الجهود الأخيرة في إطار بناء الدولة والتحديث، ولا سيما من خلال "رؤية السعودية 2030" التي أُطلقت في أبريل 2016، بهدف تنويع الاقتصاد والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، متضمنةً إصلاحات جندرية لتعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة. وشملت هذه الإصلاحات رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى 30%، إضافة إلى تطبيق سياسات "التأنيث" في قطاعات مثل البيع بالتجزئة، والتي غالبًا ما رافقها تخصيص أماكن عمل منفصلة بين الجنسين.
ورغم التقدم الملحوظ في مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ارتفعت النسبة من 10% في عام 2005 إلى 17.7% في 2016، ثم إلى 33.2% في 2022، لا تزال هناك مخاوف من اقتصار هذا التوسع على إحلال النساء محل العمالة الوافدة غير الماهرة في وظائف غير مستقرة في مجالات كالتصنيع والتجزئة والتجارة. ويشير المنتقدون إلى أن هذه الإصلاحات قد تهدف جزئيًا إلى تحسين صورة السعودية على الساحة الدولية أكثر من كونها تعبيرًا عن التزام عميق بترسيخ حقوق المرأة.
تؤكد الدراسات الحديثة حول أوضاع المرأة السعودية على التحديات التي تظهر عندما تتعارض المبادرات الحكومية مع البنية الأبوية للمجتمع. فعلى سبيل المثال، أدى تخصيص أماكن عمل منفصلة للنساء، استجابةً للتوقعات الاجتماعية لما يُعتبر بيئة عمل "مقبولة"، إلى إعاقة فرص تطورهن المهني بصورة غير مقصودة.
ولا تزال الثقافة الأبوية، المتجذرة في الأعراف القبلية والتفسيرات الدينية المحافظة، تحدّ من الفرص المتاحة للنساء، على الرغم من اعتراف الإسلام بحقوقهن في الكسب والتملك. وينتج عن هذا الواقع استمرار الفصل بين الجنسين في المجالين الاجتماعي والتعليمي وأماكن العمل. وتشير أبحاث لو رينار إلى أن بيئات العمل المنفصلة، رغم مساهمتها في توسيع مشاركة النساء في المجال العام، فإنها تعزز في الوقت ذاته الرؤى المجتمعية المحافظة. كما أن الجهود الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ولا سيما في المنظمات المختلطة، غالبًا ما تواجه مقاومة اجتماعية ودينية، الأمر الذي يعكس التفاعل المعقد بين الدولة والمجتمع والدين والمؤسسات، في سياق يتسم بتعايش الثروة الاقتصادية مع أشكال متعددة من الهشاشة.
وعلى الرغم من وفرة الأبحاث التي تناولت الهشاشة بين العمالة المهاجرة، لا يزال تقاطع الهشاشة وعدم المساواة الجندرية في السعودية – خصوصًا فيما يتعلق بدور المعايير الاجتماعية والمؤسسية والآليات التنظيمية في إنتاج أشكال خاصة من الهشاشة الجندرية – مجالًا لم يُستكشف بعمق بعد. ومن هنا، تسعى دراستنا إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليل التجارب المعيشية للهشاشة كما تُختبر داخل المؤسسات، بهدف تعميق الفهم لديناميكياتها وانعكاساتها على العلاقات الجندرية.
في دراستنا، شملنا كلًا من الرجال والنساء بهدف مقارنة تصوراتهم لظروف العمل، ومعالجة النقد الموجه للأدبيات النسوية السائدة التي غالبًا ما تغفل وجهات نظر الرجال، وفهم السياسات الجندرية وديناميكيات السلطة بشكل شامل. وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في السياق الاجتماعي-المؤسسي المعقد في السعودية، حيث يتداخل تأثير القبيلة، والطبقة الاجتماعية، والجندر في تشكيل تجارب الأفراد المتباينة. علاوة على ذلك، فإن دخول النساء مؤخرًا إلى قطاع التجزئة السعودي بعد مبادرات التأنيث يستدعي دراسة التفاعلات والديناميكيات الجديدة بين الموظفات الجدد والزملاء الذكور الحاليين.
تركز البحث على قطاع التجزئة، الذي تأثر بشكل مباشر بسياسات التأنيث الحكومية. واعتمدنا في اختيار المشاركين على أسلوب أخذ العينات الانتقائية وعينات كرة الثلج (المشاركون يرشّحون بعضهم البعض)، مستفيدين من العلاقات الشخصية لأحد المؤلفين لتحديد خمسة "حراس بوابة"، شملوا أصحاب الأعمال، وأخصائيي الموارد البشرية، ومسؤولين في الدولة، الذين ساعدونا في الوصول إلى المشاركين المحتملين. وقد كان هذا النهج ضروريًا في السياق السعودي، حيث تعتبر العلاقات الاجتماعية أساسية للوصول إلى موضوعات حساسة مثل هشاشة النوع الاجتماعي.
اشتملت معايير اختيار المشاركين على أن يكونوا مواطنين سعوديين يعملون في قطاع التجزئة المختلط بين الجنسين. وقد أجرينا 26 مقابلة شبه منظمة ومعمقة شملت 11 امرأة سعودية و9 رجال سعوديين، إضافة إلى مقابلات مع اثنين من أصحاب الأعمال، واثنين من أخصائيي الموارد البشرية، واثنين من مسؤولي الدولة للحصول على رؤى أوسع حول السياق التنظيمي. تنوعت مناصب المشاركين ومواقع عملهم بين الأسواق التقليدية ومراكز التسوق في مدينة الرياض.
أُجريت جميع المقابلات باللغة العربية بواسطة اثنين من المؤلفين السعوديين، وهو ما ساهم في خلق بيئة ثقافية ولغوية مشتركة تسهّل المناقشات الحساسة بطريقة مراعية أخلاقيا و تتطلب التجاوب المباشر. تولت الباحثة مقابلة النساء لضمان بيئة آمنة ومريحة وتقليل أي قلق متعلق بمناقشة موضوعات حساسة مثل التحرش الجنسي. وسُجلت جميع المقابلات رقميًا، واستُوفيت فيها تدابير السلامة المعتمدة خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، واستمرت المقابلة الواحدة في المتوسط بين 45 و60 دقيقة.
حصلنا على الموافقة الأخلاقية من لجنة أخلاقيات البحث في جامعة المؤلفين، كما أخذت موافقة خطية من جميع المشاركين قبل إجراء المقابلات، بما يضمن التزام الدراسة بالمعايير الأخلاقية الصارمة في البحث العلمي.
صُمم جدول المقابلات المستخدم مع الموظفين والموظفات لاستكشاف التحديات المحتملة التي يواجهها الرجال والنساء العاملون في السعودية، وكذلك تجاربهم العلائقية والشخصية في العمل. وقد استمد جدول المقابلات من أدبيات الهشاشة مع الأخذ في الاعتبار تجارب العمل والحياة للمشاركين والمشاركات، والظروف المالية، والوعي بالحماية التنظيمية (أو عدم وجودها)، والأمن الوظيفي، والآفاق الوظيفية. كما أنه تناول هدفنا البحثي المحدد المتمثل في دراسة تأثير دخول المرأة السعودية إلى قطاع التجزئة استجابةً للسياسة التي تقودها الدولة وتأثير المعايير الاجتماعية والدينية على العلاقات بين الجنسين. بالإضافة إلى ذلك، سمح نهجنا شبه المنظم بالمرونة في استكشاف المواضيع الناشئة أثناء إجراء المقابلة. بالإضافة إلى المقابلات مع الموظفين، أجرينا مقابلات مع أصحاب الأعمال وأخصائيي الموارد البشرية ومسؤولي الدولة لاكتساب فهم أوسع للتنفيذ التنظيمي لسياسات رؤية الدولة 2030 والكشف عن المعايير والمواقف الكامنة وراءها فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
خلال المرحلة الأولى من تحليل البيانات، اعتمدنا مقاربة إيميكية، أي من منظور المشاركين، أخذت بعين الاعتبار الفئات الناشئة من الفروقات الجندرية واختلال موازين القوى، ضمن السياق الزمني والجغرافي المحدد للسعودية. سمحت لنا هذه المقاربة بفهم العلاقات الجندرية وتفاعلات المشاركين والمشاركات في العمل، بالإضافة إلى تجاربهم في أماكن العمل المختلطة بين الجنسين. لقد درسنا كيف تفاعلت البنى الفردية للنوع الاجتماعي مع المعايير الاجتماعية-المؤسسية والدينية والثقافية والعوامل التنظيمية في تشكيل الهشاشة في قطاع البيع بالتجزئة. في المرحلة الأولى، قمنا بتحديد الفئات الناشئة التي تميز العلاقات بين الجنسين وتجارب المشاركين، ونظمنا البيانات القابلة للمقارنة معًا في فئات مؤقتة (رموز من الدرجة الأولى). في المرحلة الثانية، استُخدم الترميز المحوري لدمج الفئات من الدرجة الأولى في مواضيع ناشئة ذات صلة بمصدر الهشاشة والاستجابات لها. وكشف التحليل عن تعايش أشكال الهشاشة الهيكلية والذاتية من الهشاشة. تم تجميع الرموز المتعلقة بـ"التدخل الحكومي" و"الممارسات الجندرية التنظيمية" كمصادر محتملة للهشاشة الهيكلية، في حين تم تجميع مشاعر المشاركات وتجربة المعايير الاجتماعية والتمييز الجندري والتحرش الجنسي كمظاهر محتملة للهشاشة الذاتية. في المرحلة الثالثة، قارنا بين المواضيع الرئيسية التي تم تحديدها لوضع اللمسات الأخيرة على تحليلنا للأنماط متعددة الأبعاد والعلاقات ومصادر الهشاشة مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير التغيرات الهيكلية والرموز الاجتماعية والدينية والعلاقات بين الجنسين. تضمنت هذه العملية تحليلًا فرديًا من قبل كل مؤلف، تلاه تحليل مشترك لضمان الصلاحية والموثوقية.
النتائج
في سياق السعودية، كشف تحليلنا عن شكلين أساسيين من الهشاشة يتأثران بالتفاعل بين سياسات الدولة الأبوية والمعايير الثقافية. ينشأ الشكل الأول وهو الهشاشة الهيكلية، من عوامل اجتماعية مؤسسية تشمل المبادرات الحكومية والمعايير الاجتماعية الدينية والسياسات التنظيمية، والتي تشكل مجتمعةً تجارب التوظيف لدى العاملين في قطاع التجزئة. أما الشكل الثاني، وهو الهشاشة الذاتية، فيعكس التجارب الفردية لهؤلاء الموظفين. فقد عانى الرجال من عدم اليقين المتزايد والتحديات التي تواجه دور الرجل المعيل التقليدي، مما أدى إلى الشعور بعدم الأمان وتعطيل أيديولوجية الأسرة المتمحورة حول الرجل. وعلى العكس من ذلك، واجهت النساء هشاشة ذاتية من خلال الظهور المتزايد في الأماكن العامة، وهو تحول ملحوظ عن أدوارهن المجتمعية التقليدية. وغالبًا ما أدى هذا الظهور الجديد إلى مخاوف أو تجربة التحرش الجنسي وتراجع المكانة الاجتماعية المتصورة، مما يوضح التأثير المعقد للمعايير الأبوية المتطورة على تجارب توظيفهن.
الهشاشة الهيكلية
أدى الاعتماد على العمالة الوافدة التي تشكل 51.2% من إجمالي سوق العمل في السعودية و77.4% من القطاع الخاص، إلى سياسات التوطين على مستوى الدولة من أجل تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز توظيف السعوديين. استهدفت هذه السياسات في البداية فرص العمل للرجال السعوديين على وجه التحديد. ومع ذلك، شجع برنامج التأنيث لعام 2011 الذي استهدف قطاع البيع بالتجزئة على توظيف النساء السعوديات في قطاعات مثل محلات الملابس الداخلية، وهو ما يمثل مثالًا بارزًا على التفاعل بين الثقافة الأبوية وسياسات الدولة كما هو موضح في نظرية والبي للنظام الأبوي. وعلى الرغم من أن هذه المبادرة، على الرغم من أنها تقدمية، إلا أنها دعمت أيضًا معايير الفصل بين الجنسين، مع وجود أقسام مخصصة للنساء فقط في أماكن العمل، مما يدل على دور الدولة في تعزيز الهياكل الأبوية. ويبدو أن هذا النهج يعكس محاولة لتحقيق التوازن بين التوقعات الاجتماعية والثقافية المتجذرة في المعايير الدينية والتقليدية وبين أهداف التحديث الاقتصادي. وتشير هذه الاستراتيجيات إلى أن إدماج المرأة في القوى العاملة، رغم أنه تقدمي في ظاهره ويخدم الأهداف الاقتصادية، إلا أنه ربما يفتقر إلى التزام أعمق بالمساواة الحقيقية بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار السياق الديني والثقافي للمجتمع السعودي.
وكانت إحدى النتائج الرئيسية لهذه السياسات، ولا سيما برنامج التأنيث 2011-2016، زيادة غير مقصودة في عدم الاستقرار. توضح هذه النتيجة الطرق الدقيقة التي يمكن من خلالها لمبادرات الدولة، التي تهدف إلى دمج المرأة في القوى العاملة، أن تخلق في الوقت نفسه أشكالًا جديدة من عدم الاستقرار الوظيفي والنفسي، وكما ذكر أحد رجال الأعمال
أولًا، كانت المبادرة [برنامج التأنيث] خطوة رائعة بغض النظر عن أي شيء، ماذا تفضل المرأة؟ الحصول على وظيفة أدنى أو البقاء في المنزل بلا دخل ولا عمل ولا تطوير للذات، لذا بالطبع، إنها خطوة للأعلى مهما كانت. (لكن) بالطبع، بالطبع، هن في وظائف أدنى... (في) القاع (رجل أعمال 2، شريك في شركة أدوية).
أدى برنامج التأنيث، الذي يهدف إلى الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة غير الماهرة وتسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل، إلى زيادة ملحوظة في عدد النساء السعوديات في وظائف التجزئة منخفضة الأجر، مع نمو كبير في قطاعات مثل الأغذية (زيادة بنسبة 40% منذ عام 2019) والخدمات المساندة (زيادة بنسبة 37%)، تسلط هذه النتائج الضوء على مفارقة سياسات الدولة التي، في الوقت الذي تعمل فيه على تحديث عمل المرأة، تخلق أيضًا عن غير قصد أشكالًا جديدة من الهشاشة الجنسانية. كان هذا التأثير واضحًا في انعكاسات المشاركين والمشاركات على هذه السياسات في قطاع التجزئة:
يعود السبب وراء دخول المرأة إلى المؤسسة إلى (مبادرات) التوطين والتأنيث في السعودية. قبل عام 2011 [وهو العام الذي أُطلق فيه برنامج التأنيث]، كان من النادر أن نرى نساءً يعملن في قطاع التجزئة (رجل الأعمال 1، صاحب محلات إكسسوارات).
تعمل النساء الآن في المصانع والمستودعات... كانت الشركة في البداية محافظة للغاية. ولكن ... مع كل هذا التمكين [للنساء]، بدأوا في جلب المزيد من النساء (امرأة مشاركة 10، مسؤولة شؤون الموظفين).
تؤكد هذه الروايات على دور المبادرات التي تقودها الدولة في تغيير التركيبة الجنسانية لقطاعات محددة، مما يؤدي بشكل خاص إلى تركز النساء السعوديات في الوظائف ذات الأجور المنخفضة واحتمال زيادة هشاشة سوق العمل. كشفت المقابلات التي أجريت مع مسؤولين حكوميين عن وعي الحكومة بالتحديات المرتبطة بـ "برنامج التأنيث" الذي يستهدف توظيف النساء السعوديات في القطاعات التي يهيمن عليها الذكور تقليديًا مثل قطاع التجزئة. واعترف المسؤولون بأن البرنامج لم يحقق الهدف المرجو منه. وكما ذكر أحد المسؤولين الحكوميين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
في الماضي، كان لدينا اشتراطات في الوزارة بأن أي مكان عمل لتوظيف النساء يجب أن يكون فيه قسم نسائي (منفصل). وكعمل تجاري، لتوظيف النساء هناك عبء اقتصادي وهو تكلفة تقسيم مكان العمل. لذا، كان من الطبيعي أن تقول "لماذا أوظف النساء؟ " وتحمل هذه التكاليف؟ ... كنت تفضل توظيف الرجال... لذلك اتخذت الحكومة قرار تأنيث بعض المتاجر. (لكن) يجب أن أعترف أن تأنيث الوظائف لم يحقق أهدافه. (فقد) خلق صورة نمطية للوظائف التي يمكن أن تشغلها النساء. لم يقم بتمكين المرأة، بل خصص وظائف منخفضة الأجر للنساء... (وهو) أمر مهين ومذل... لذا... الآن... توجه الوزارة هو (أنه) لا توجد وظيفة لجنس واحد فقط (مسؤول حكومي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
وتؤكد الاقتباسات على أن سياسة الدولة في تعزيز عمل المرأة السعودية، على الرغم من حسن النية، إلا أنها أدت عن غير قصد إلى هشاشة هيكلية. فقد تم دفع النساء إلى خيارات وظيفية تتسم بهياكل وظيفية غير واضحة وساعات عمل طويلة والحد الأدنى للأجور. وقد أدى التطبيق السريع والصارم لهذه المبادرة، مع فرض غرامات على الشركات التي لم تستوفِ العدد المطلوب من الموظفات السعوديات، إلى فرض ضغوط هائلة على أصحاب الأعمال التجارية وأدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة:
تخيل أنك تفتتح مستشفى و(يقولون) "ليس لديك طبيبات؛ سأعطيك غرامة مالية". ستقولين "(لا توجد) طبيبات (متاحات)" سيقولون "نحن لا نهتم، عليك أن تجد حلًا لذلك." ... أنا صغير الحجم وليس لدي الموارد اللازمة لتنفيذ (هذه السياسة) بنجاح. لقد حصلوا على أصغر الأشخاص وطلبوا منهم أصعب الأشياء لتنفيذها (صاحب عمل - محلات إكسسوارات).
تهدف رؤية 2030، التي تم تقديمها في عام 2016، إلى اقتصاد أكثر شمولًا وتنوعًا مع تعزيز أدوار المرأة في مختلف القطاعات، مما يمثل تحولًا كبيرًا من التأنيث القطاعي إلى شكل أوسع بكثير من الإدماج. وعلى الرغم من أن هذه السياسات تقدمية، إلا أنها تؤكد أيضًا على الطبيعة الأبوية من أعلى إلى أسفل للإصلاحات، وهو جانب رئيسي في إطار عمل والبي. وتمثل خطوة القضاء على الفصل بين الجنسين الذي تقره الدولة في قطاع التجزئة خطوة كبيرة نحو أماكن عمل محايدة/شاملة للجنسين، إلا أنها تخاطر بالتصادم مع القيم الثقافية الإسلامية والقبلية التقليدية. ويوضح هذا السياق الفريد من نوعه تنظير والبي بأن جهود الدولة لتصحيح أوجه عدم المساواة بين الجنسين قد تعززها أحيانًا دون قصد، خاصة عندما لا تأخذ بالحسبان الثقافة الأبوية الراسخة. تستكشف النتائج التي توصلنا إليها هذا الانتقال الحرج، وتسلط الضوء على التحول في تجربة النساء من شكل من أشكال الهشاشة الموضوعية التي حرضت عليها سياسات الدولة الأولية، إلى شكل آخر ناجم عن التوتر بين مبادرات الدولة والمعايير الأبوية. ويتجلى ذلك بشكل ملحوظ في الإزالة المفاجئة للمساحات التي تفصل بين الجنسين في تجارة التجزئة، كما يتضح من التجارب التي شاركتها المشاركات في الدراسة:
بصراحة، عندما بدأت لأول مرة، التقى والدي بمدير أعمالي. لذا، إذا تم توظيفنا [أنا وأخواتي] في أي مكان، يلتقي والدي بالمدير أولًا. إذا شعر أنه شخص جيد فقد يوافق (أنا) على العمل (امرأة 2، بائعة، 24 سنة).
لو اتبعنا الأعراف والتقاليد لما عملنا أو غادرنا المنزل. ولكن نظرًا لظروفنا، احتجت (احتجت) إلى العمل. أحاول أن أكون محتشمة وأعتني بصورتي وسمعتي ولا أرفع صوتي... عندما أعمل مع الرجال، أحافظ على حدودي وخصوصيتي. (امرأة مشاركة 3، بائعة)
تسلط هذه الاقتباسات الضوء على الكيفية التي تفرض بها المعايير الأبوية والتوقعات المجتمعية قيودًا على المرأة في مكان العمل. وعلى الرغم من حرص النساء على العمل وحاجتهن إليه، إلا أنهن مضطرات إلى التعامل مع هذه الأعراف المتجذرة، حيث يضطررن إلى الموازنة بين الحاجة إلى التفاعل المهني مع الزملاء الذكور وبين الحاجة إلى الحفاظ على صورتهن وسمعتهن. هذه الطبقة الإضافية من التفاوض المجتمعي، حيث توفق المرأة بين تطلعاتها الوظيفية والتوقعات التقليدية، تجسد التفاعل المعقد بين المعايير الأبوية ومساعي المرأة في العمل، مما يساهم في الهشاشة الهيكلية التي تواجهها. يسلط المالك المشارك لسلسلة متاجر أدوية الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة في البيئات المختلطة بين الجنسين، بما في ذلك رفض الأسرة والتهديد المتصور للأعراف الاجتماعية المحافظة. وأكد على المقاومة الثقافية التي تواجهها أثناء تنفيذ رؤية 2030، قائلًا:
تقريبًا في عام 2017 تقريبًا... شهد سوق العمل قرفًا كبيرًا مع إزالة الفصل بين الجنسين. كان هذا أمرًا غريبًا جدًا بالنسبة لنا... لم يكن أحد يقبل أن تخرج المرأة (للعمل). لذا، عندما يأتي الأب مع ابنته ويطلب منا شرح الوظيفة، نقول له إنها وظيفة ستكون فيها النساء في الصيدلية، ولكن عندما نذكر أن هناك (ذكور) في الصيدلية، يقولون "توقفوا، لن نقوم بذلك. شكرًا لكم." لقد فتحنا حوالي 40 وظيفة شاغرة ولم نتمكن من توظيف سوى 10 فقط... (رجل أعمال 2، شريك في شركة أدوية).
وتسلط رواية الشريكة في العمل الضوء على مقاومة توظيف النساء في الأماكن المختلطة بين الجنسين، مما يعكس التأثير المتجذر للثقافة الأبوية حيث تتردد الأسر في كثير من الأحيان في السماح للنساء بالعمل مع زملائهن الذكور. وتؤدي هذه المقاومة إلى إدامة الهشاشة الموضوعية للمرأة من خلال تقييد خيارات التوظيف المتاحة لها وتعزيز الأدوار التقليدية للجنسين. بالإضافة إلى ذلك، أكد بعض المشاركين الذكور في دراستنا على أن تدخلات الدولة في سوق العمل تعطل الهياكل الاجتماعية وتتعارض مع القيم الإسلامية. وأشار أحد المشاركين إلى ما يلي
المجتمع بدوي، ورؤية (2030) لا تتماشى مع ما اعتدنا عليه. لست أنا وحدي، فمجتمعي الصغير يتفق على أن المرأة لا مكان لها في الخارج، المرأة يجب أن تكون في البيت. فإما أن يبقين في المنزل أو أن يجدن عملًا نسائيًا بالكامل... الرجال لا يحسنون التصرف، ولا تعرفين ما قد يحدث. (مشارك ذكر 2، مندوب مبيعات)
يوضح هذا الاقتباس التوتر بين مبادرات الدولة التقدمية والمعايير الاجتماعية والدينية المحافظة الراسخة داخل الثقافة الأبوية، مما يجسد استمرار النظام الأبوي للدولة الذي وصفته والبي. كما يتجلى هذا التوتر في تخصيص المناصب الوظيفية من قبل مديري وأصحاب المتاجر الذين يواصلون الالتزام بالأدوار التقليدية للجنسين وإدامة التقسيم الجندري للعمل. ومن خلال تعيين النساء في أدوار "ملائمة" اجتماعيًا، تعزز هذه الممارسات المعايير الأبوية في المؤسسات وتسهم في الهشاشة الموضوعية التي تعاني منها النساء في القوى العاملة.
في متجر الكتب، الوظائف المتاحة في المكتبة هي إما بائعة أو أمينة صندوق. ومعظم الموظفات (لا يعملن) في القسم المختلط من المكتبة، (لذلك) لا يوجد لديهن سوى وظائف الكاشير (مشارك ذكر 7، مفتش عام)
أنا مدير وأتحكم في فرعين. وقد (وضعت) القواعد التي أراها مناسبة. فعلى سبيل المثال، لديّ قاعدة تمنع دخول الرجل إلى المحل بمفرده في المحل، فهذا ممنوع تمامًا، ولا أريده. إذا حدث ذلك، ستتم معاقبة الفتاة. (رجل أعمال 1، صاحب محل إكسسوارات)
كما كان هناك اعتراف واسع النطاق بين الرجال، أصحاب المتاجر والموظفين، بأن النساء العاملات في المتاجر يتقاضين أجورًا أقل من الرجال عن نفس الوظائف:
وبالطبع، لن يقبل السعوديون الذكور بأجور أقل من أجور السعوديات... فالإناث السعوديات أكثر كفاءة 100 مرة من السعوديين الذكور. هذه المعلومة التي لا أخبر بها الجميع... حتى لا يقول الناس "إنه يدلل نساءه (الموظفات)" (صاحب عمل - محلات إكسسوارات)
تُظهر النتائج التي توصلنا إليها كيف يمكن للمعايير الأبوية الدائمة في سوق العمل التي يهيمن عليها الذكور أن تقوض سياسات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة والحد من عدم المساواة بين الجنسين. في قطاع التجزئة السعودي، الذي يتميز بالوظائف ذات الأجور المنخفضة وسوء التنظيم، حددنا جانبًا جندريًا واضحًا من الهشاشة الهيكلية. فقد واجهت النساء مستويات أعلى من الهشاشة بسبب طبيعة الأدوار الموكلة إليهن في قطاع سوق غير آمن بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، أضاف التفاعل بين المعايير الاجتماعية والمؤسسية والسياسات التنظيمية، بما يتماشى مع المعايير الأبوية، توترًا إلى بيئات عملهن. وعلى الرغم من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحسين فرص العمل للنساء، تكشف النتائج التي توصلنا إليها أن هذه السياسات في قطاع التجزئة غالبًا ما تكرر في قطاع التجزئة الهشاشة المجتمعية للنساء. فقد دُفعت النساء إلى أدوار هامشية بأجور منخفضة ومزايا ضئيلة، مما يعكس أوجه عدم المساواة بين الجنسين الراسخة واختلال موازين القوى في علاقات العمل. توسع النتائج التي توصلنا إليها الفهم الحالي للعمالة غير المستقرة من خلال تسليط الضوء على تقاطعها مع النوع الاجتماعي والتدين، بما يتماشى مع الأبحاث التي تسلط الضوء كيف يمكن للعوامل الاجتماعية والثقافية أن تشكل اندماج المرأة في سوق العمل. نحن نساهم في الأدبيات حول التقاطع بين الجنسين والهشاشة في مكان العمل من خلال تفصيل كيف أن التديّن، مقترنًا بالنوع الاجتماعي، لا يؤثر فقط على أدوار النساء وأنشطتهن، بل قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم تهميشهنّ والتمييز ضدهنّ في العمل، وبالتالي تعزيز الهشاشة الهيكلية. يسلط هذا التحليل الضوء على الديناميات المعقدة للنوع الاجتماعي والتدين في سوق العمل في السعودية، ويوضح دورهما المحوري في تشكيل ظروف عمل المرأة غير المستقرة. ونجادل بأن الهشاشة الهيكلية تتشكل من خلال التفاعل بين السياسات الموضوعية والمعتقدات الاجتماعية والدينية والإجراءات التنظيمية، مما يؤدي إلى شكل متميز ومتعدد الأوجه من أشكال الهشاشة، خاصة عند النظر في التفاعل بين الدولة الأبوية والثقافة الأبوية.
التجارب الذاتية للهشاشة
ارتبطت التجارب الذاتية للهشاشة بين المشاركات لدينا من النساء ارتباطًا وثيقًا بزيادة الظهور الناتج عن العمل جنبًا إلى جنب مع الرجال في بيئات غير منفصلة، مما يمثل تحولًا كبيرًا في ديناميكيات النوع الاجتماعي. وقد أدى هذا التغيير التدريجي إلى سيناريوهات صعبة، لا سيما زيادة خطر التحرش الجنسي، مما يعكس المعايير الأبوية المتجذرة التي غالبًا ما تُشيّء النساء. تسلط مثل هذه التجارب، التي تتماشى مع عمل والبي، الضوء على كيف أن التحول المؤسسي نحو دمج النوع الاجتماعي قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط الأبوية واختلال موازين القوى. وقد أظهرت الدراسات أن النساء في المهن التي يهيمن عليها الذكور مع ضعف اجتماعي واقتصادي أكثر عرضة للتحرش، وقد اعتبرت تجارب المشاركات لدينا، بما في ذلك حالات الاهتمام والتحرش الجنسي غير المرغوب فيه كجزء من حياتهن العملية اليومية، أمرًا حتميًا تقريبًا. هذه التجارب أعادت إنتاج وتعزيز ديناميكيات السلطة الأبوية المجتمعية داخل أماكن العمل وساهمت في شعور النساء الذاتي بالهشاشة. على سبيل المثال، روت إحدى المشاركات تعليقًا مزعجًا لأحد الزبائن:
قال أحد الزبائن ذات مرة: "أنا مستعد أن أخطفك من مكان عملك وأجبرك على فعل ما أريده ثم أعيدك...". هناك أيضًا بعض الإيماءات أو الكلمات ... من الزبون (الزبائن) التي تعتبر مهينة جدًا ولا يجب أن تقال في مكان عام. جاء أحد الزبائن وجلس على السرير وظل يفعل أشياء وطلبت منه المغادرة وإلا سأتصل بالأمن. قلت له: "كن محترمًا واخرج الآن" فقال لي: اهدئي، لا داعي لكل هذه (الدراما)" (امرأة مشاركة 6، مندوبة مبيعات).
وتسلط هذه الحوادث الضوء على الهشاشة التي تواجهها المرأة في الأماكن التي يهيمن عليها الذكور، خاصة في سياقات مثل السعودية، حيث يتم تحدي المعايير التقليدية بين الجنسين، بما في ذلك الفصل بين الجنسين المتغاضى عنه دينيًا، في مكان العمل. يمكن اعتبار المضايقات من الزملاء والزبائن الذكور شكلًا من أشكال المقاومة لدخول المرأة إلى أماكن العمل التي تفرضها الدولة، مما يعمل على الحفاظ على اختلال موازين القوى التي ترمز إلى الثقافات الأبوية وتضخيمها. هذا الشكل من أشكال التحرش هو مظهر مباشر للنضال ضد تقدم المساواة بين الجنسين في مكان العمل. شاركت إحدى المشاركات من أمينة الصندوق تجربتها مع أحد الزبائن:
لقد واجهت إساءة جسدية من أحد العملاء، حيث قام برمي شيء ما عليّ، لأنه أراد أن يتم خدمته (أولًا). طلب مني مديري أن أتحمل ذلك لأننا يجب أن نحقق أهدافنا المالية. (امرأة مشاركة 5، أمينة صندوق)
واجهت الإناث المشاركات في دراستنا أيضًا مضايقات ومغازلات غير مرحب بها من زملائهن الذكور:
أحد زملائي، قال لي إنه يريد أن يتعرف عليّ أكثر. طلب مني أن نبدأ الحديث لنتعرف على بعضنا البعض وقال لي "أنا أحبك" وما إلى ذلك. وعندما رفضته، بدأ في إهانتي وبدأ في مضايقتي وبدأ في مضايقتي والإساءة إلي وبدأ في أخذ الزبائن مني لإزعاجي (امرأة مشاركة 6، مندوبة مبيعات).
وقد سردت العديد من المشاركات في الدراسة اقتباسات مشابهة لما ذكرناه أعلاه، مما يؤكد على الطبيعة الواسعة الانتشار للتحرش في مكان العمل. لا تسلط هذه الروايات الضوء على تواتر التجارب المؤلمة فحسب، بل أيضًا على نقص الدعم في مكان العمل ومظاهر التحرش كشكل من أشكال المقاومة لوجود المرأة في هذه الأماكن. وقد ساهم ذلك في زيادة إحساس النساء بالهشاشة الذاتية. وعلاوة على ذلك، تعكس هذه التجارب سياقًا أبويًا أوسع نطاقًا، تكرسه هياكل الدولة والمجتمع. وهذا يتوافق مع نظرية والبي، التي تُظهر كيف يمكن للتغيرات في ديناميكيات النوع الاجتماعي في مكان العمل أن تضخّم الضغوط والتحديات الأبوية في تحقيق المساواة بين الجنسين في بيئات ذات معايير أبوية راسخة بعمق.
في دراستنا، ربطت العديد من المشاركات بين زيادة التحرش والاهتمام غير المرغوب فيه من قبل الزملاء الذكور وبين شعور الرجال أنفسهم بعدم الاستقرار. فقد أدت المبادرات التي تقودها الدولة، مثل حصص النساء في قطاع التجزئة، إلى تقليص فرص العمل للرجال، وهو ما اعتبرته تهديدًا لمعيشتهم. ومع ذلك، ظل يُنظر إليهم اجتماعيًا على أنهم المعيلون الرئيسيون في المجال المنزلي/الأسري. وقد أبرز العديد من المشاركين الذكور هذا الشعور المتزايد بانعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي لدى الموظفين الذكور:
قامت الشركة بتوظيف النساء (وفقًا) لتعليمات الوزارة ... المتعلقة بتمكين المرأة. من مصلحة الشركة تمكين النساء... إن إعطاء الأولوية للنساء سيساعدهم في تحقيق الحصة المقررة. لذا، فبدلًا من توظيف 100 رجل، يفضلون توظيف 50 امرأة (ذكر مشارك 4، مدير صيدلية).
ومن الواضح في مسح القوى العاملة الربع سنوي أن البطالة بين الإناث قد انخفضت بينما ارتفعت بين الذكور... وهذه ليست الطريقة المثلى لتحقيق التوازن في سوق العمل المشوه (ذكر 1، مدير صيدلية).
أرى أن رؤية دعم عمل المرأة أمر جيد، ولكن ... في بعض الأحيان إذا تقدم رجل وامرأة للعمل، فإنهم يفضلون النساء... هذا غير عادل بعض الشيء للرجال... دعم توظيف النساء مبادرة ممتازة ولكن (على حسابنا) كرجال (مشارك ذكر 4، مدير صيدلية)
نتيجة للمعايير الأبوية التي كرستها كل من الدولة الأبوية ونموذج المعيل السائد، عانى الرجال من فقدان السيطرة في سوق العمل الذي كانوا يهيمنون عليه تقليديًا. وهذا ما يسلط الضوء على التأثير السائد للثقافة الأبوية، كما أكد والبي، والضغط الواقع على الرجال ليكونوا المعيلين الأساسيين لأسرهم. وقد أدى التحول الناتج عن ذلك في سوق العمل إلى تفاقم انعدام الأمن المالي والمخاوف من الفشل في أدوارهم كمعيلين. شارك أحد المشاركين، وهو مندوب مبيعات، إحباطه وتخوفه:
أنا أعتني ماليًا بوالدي وأختي. كل راتبي يذهب إليهم. كانت هناك وظائف تقدمت إليها... وكنت متحمسة للعمل في هذه الوظيفة (لأن) راتبها جيد... (لكن) قالوا إنهم بحاجة إلى إناث. هذا ما يزعجني. إذا كنت ذكرًا ذا تعليم منخفض، فمن الصعب عليك العثور على وظيفة (على أي حال). (الآن) تم تخصيص جميع الوظائف لذوي التعليم المنخفض للإناث. (مشارك ذكر 2، مندوب مبيعات).
يجب أن تكون الأولوية ... للرجل. إذا لم يكن موظفًا، فلن يكون قادرًا على الزواج أو تكوين أسرة أو تربية أسرته... لن يتزوج أحد من رجل عاطل عن العمل. لن يقبل أحد (رجل) إذا لم يكن لديه دخل ثابت (مشارك ذكر 4، مدير صيدلية).
سلّط المشاركون الضوء على التركيز المجتمعي العميق على قدرة الرجل على العمل، وهو أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل تحقيق إنجازات شخصية مثل الزواج، بل أيضًا لتحقيق التوقعات المجتمعية. إن ترسيخ إيديولوجية الرجل المعيل وعلاقاتها بالثقافة الأبوية، يؤكد على التأثير السائد للأدوار التقليدية للجنسين. في السعودية والمجتمعات الأبوية المماثلة، تفرض الممارسات الثقافية والدينية، مثل المهر (تقديم الرجل المال أو الهدية لعروسه قبل الزواج) وتغطية نفقات الزفاف، ضغوطًا مالية كبيرة على الرجال. ويمكن أن يؤثر الفشل في الوفاء بهذه الالتزامات على فرص الزواج، مع ما يترتب على ذلك من آثار طويلة الأجل على النسيج الاجتماعي الأوسع. ونتيجة لذلك، أعرب العديد من المشاركين الذكور عن مقاومتهم لإصلاحات سوق العمل التي تحابي المرأة، معتبرين إياها تحديًا لدورهم كمعيلين أساسيين وللمعايير الجنسانية الراسخة.
أدت تجربة التحرش في مكان العمل وما ترتب عليها من هشاشة واجهتها النساء في دراستنا إلى استراتيجيات مختلفة للتكيف. فقد اعتمدت النساء تدابير مثل ارتداء الملابس المحتشمة، وارتداء الحجاب، وعدم مغادرة المكتب إلا برفقة نساء أخريات، وتقليل التعامل مع الرجال لتجنب التحرش. تعكس هذه التكتيكات الالتزام بالمعايير الأبوية، مثل الاحتجاب عن نظرات الرجال كشكل من أشكال الحماية. ومن المثير للاهتمام أن بعض من أجريت معهن المقابلات، في دعمهن لبعضهن البعض ضد التحرش، تبنين عن غير قصد مبادئ نسوية مثل الأخوة. وهذا يدل على إمكانية تنمية الوعي النسوي، حتى عندما لا يتم ذلك عن قصد. ومع ذلك، كانت هذه الاستراتيجيات مجرد آليات للتكيف على المستوى الجزئي وكان المعيار السائد هو الصمت وعدم الإبلاغ عن التحرش والسلوكيات غير اللائقة من قبل الذكور. وغالبًا ما كان هذا التردد نابعًا من خوف النساء من الإضرار بسمعتهن أو سمعة عائلاتهن، وفي بعض الحالات، الخوف من تحميلهن مسؤولية الحادث. هذا الصمت، المتجذر في الخوف، يسلط الضوء على ديناميكيات السلطة في الثقافة الأبوية، حيث قد تشعر النساء بأنهن مضطرات لحماية سمعة المتحرش أو شخصية ذكورية خارجية بدلًا من السعي لتحقيق العدالة لأنفسهن. وأوضحت إحدى المشاركات من البائعات وجهة نظرها:
إذا رأيت مثل هذه السلوكيات غير اللائقة فأنا ببساطة أتجاهلها. أشعر أنه أمر لا يستحق العناء. ... لو تم التحرش بي، سأسامحه. أشعر بالسوء لكوني السبب في إنهاء عقده وفقدانه مصدر رزقه (امرأة مشاركة 2، بائعة).
وأشار الشريك في ملكية شركة أدوية:
كان لدينا حالة لموظفة تعرضت للتحرش من قبل زميلها الرجل، واستغرق الأمر أسبوعين للإبلاغ عن ذلك. سألناها: "لماذا انتظرتِ أسبوعين؟" قالت لا أريد أن أقطع رزقه. (رجل أعمال 2، شريك في ملكية شركة أدوية)
وفي كثير من الحالات، كانت هؤلاء النساء هن المعيلات الوحيدات أو المساهمات الرئيسيات في دخل الأسرة. وقد أدى هذا الضعف الاجتماعي والاقتصادي والحاجة إلى الحفاظ على العمل إلى زيادة تجربتهن الذاتية في عدم الاستقرار إلى الحد الذي جعلهن لا يبلغن عن حالات التحرش الجنسي.
... بعض (النساء) خائفات ... من التسبب في مشكلة. فهم لا يريدون أن تكبر المشكلة... قد يقول أهل الفتاة إن هناك تحرشًا في بيئة العمل ومن ثم يجبرون الفتاة على ترك عملها (رجل أعمال 2، شريك في شركة أدوية)
عادةً ما تخشى النساء الحديث عن التحرش. يخشين أن ينكشف أمرهن... و يخشين الفصل من العمل. (امرأة مشاركة 1، مساعدة مدير في متجر)
هناك الكثير من النساء اللاتي يحتجن إلى هذا العمل حتى لا يستطعن الإبلاغ عن مديرهن. لذا، هناك بعض النساء، أعرف سبب حاجتهن للعمل في هذه البيئة... لأنه ليس لديهن فرصة أخرى. (امرأة مشاركة 2، بائعة)
تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على وجود طبقة إضافية من الهشاشة الذاتية من قبل الرجال والنساء على حد سواء في سياق قطاع التجزئة في السعودية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنظرية والبي حول الثقافة الأبوية ونفوذ الدولة. فبالنسبة للرجال، تنبع هذه الهشاشة من اضطراب متصور في المعايير التقليدية بين الجنسين على خلفية الإطار المجتمعي الأبوي الذي يدعم نموذج الرجل المعيل. من ناحية أخرى، تواجه النساء هشاشة ذاتية من خلال التحرش الجنسي المتفشي، والخوف من فقدان الوظيفة، وانعدام الأمن الاقتصادي، والمخاوف المجتمعية من الإضرار بالسمعة. من خلال الاعتراف الصريح بتأثير الثقافة الأبوية ودور الدولة، تكشف النتائج التي توصلنا إليها عن تعقيدات الديناميات الجندرية والعوامل المتداخلة التي تساهم في زيادة الهشاشة التي يعاني منها كل من الرجال والنساء في سياق إصلاحات سوق العمل.
المناقشة والخلاصة
تقدم دراستنا بشكل كبير فهم الهشاشة من خلال تسليط الضوء على طبيعتها متعددة الطبقات، وتحديدًا التفاعل المعقد بين الثقافة الأبوية وسياسات الدولة وتقاطع النوع الاجتماعي والتدين والسلطة. من خلال استكشاف كيفية مساهمة المعايير الجندرية والمبادرات التي تقودها الدولة في الهشاشة الهيكلية، نقدم رؤى حول التجارب الأكثر ذاتية للهشاشة في ظل الخلفية الاجتماعية المؤسسية في السعودية. وبالاستناد إلى نظرية والبي، نرصد التفاعل المعقد بين الثقافة الأبوية والدولة الأبوية، ونسلط الضوء على كيفية تأثير هذه العوامل مجتمعة على تجارب سوق العمل لكل من النساء والرجال. يسلط بحثنا الضوء على الدور الهام للدولة الأبوية في تشكيل كل من انعدام الأمن الوظيفي لدى النساء وشعور الرجال بانعدام الأمن، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير المعتقدات الدينية والأعراف الاجتماعية.
يساهم بحثنا في المعرفة النظرية والتجريبية بعدة طرق رئيسية. أولًا، نحن نوسع فهمنا للهشاشة بما يتجاوز التصنيف الثنائي لظروف العمل أو كتجربة ذاتية للشعور بالهشاشة. تسلط دراستنا الضوء على الحاجة إلى النظر في كل من الهشاشة الموضوعية والذاتية، مع الاعتراف بدور الدولة والمعايير المجتمعية في تشكيل هذه التجارب. وهذا يتماشى مع الانتقادات التي وجهها لامبرت وهيرود (2016) وكاليبرغ (2009) بشأن محدودية مراعاة أدبيات الهشاشة للسياق الاجتماعي الأوسع. وتكشف النتائج التي توصلنا إليها عن تأثير المعتقدات المجتمعية والثقافية، لا سيما في إدامة الفصل بين الجنسين وتشكيل المواقف تجاه عمل المرأة. على سبيل المثال، تسلط تجارب النساء السعوديات في دراستنا الضوء على أشكال مرئية من الهشاشة الهيكلية، مثل إحالتهن إلى وظائف منخفضة الأجر في المجالات التي يهيمن عليها الذكور، إلى جانب الهشاشة الهيكلية غير المرئية، النابعة من المعايير المجتمعية التي تقيد وجود المرأة في بيئات العمل المختلطة بين الجنسين. من خلال التقاط التفاعل المعقد بين المعتقدات الاجتماعية-الدينية والآليات الاجتماعية-المؤسسية والإجراءات التنظيمية، تساهم دراستنا في توفير فهم أعمق للهشاشة كظاهرة متعددة الأوجه. وبالتالي، يؤكد بحثنا على أهمية النظر في السياق الاجتماعي الأوسع والتفاعل بين مختلف العوامل في تشكيل أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتجارب الهشاشة.
وتتمثل مساهمتنا الثانية في الأدبيات المتعلقة بالهشاشة في تطبيق عدسة فالبي الخاصة بهياكل النظام الأبوي، والتي تسلط الضوء على الطبيعة المتعددة الطبقات للهشاشة وتفاعلها مع الثقافة الأبوية والدولة الأبوية. تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على العواقب غير المقصودة للمبادرات الحكومية الرامية إلى تأنيث قطاع التجزئة بين عامي 2011 و2016. وفي حين أن هذه المبادرات هدفت إلى معالجة بطالة النساء والالتزام بمعايير الفصل بين الجنسين، إلا أنها دفعت النساء عن غير قصد إلى وظائف غير مستقرة مما أدى إلى ما صنفته الأدبيات الموجودة على أنه تجارب موضوعية للهشاشة. ومع ذلك، في عام 2016، عندما ألغت الدولة شرط الفصل بين الجنسين، ظهر شكل جديد من أشكال النظام الأبوي المعاصر، مما يعكس الصدام في كثير من الأحيان بين الحداثة والتقاليد المحافظة. تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن دخول المرأة إلى القطاعات التي يهيمن عليها الذكور تقليديًا في سوق العمل السعودي، إلى جانب التحول المستمر للدولة، أدى إلى تكثيف الهشاشة الموضوعية للمرأة وظهور شكل جديد من أشكال الهشاشة الذاتية. وقوبل هذا التحول بمقاومة من الزملاء الذكور، مما يعكس الأنماط التي لوحظت في سياقات أخرى حيث ينظر الرجال إلى دخول المرأة إلى القوى العاملة على أنه تهديد. في المملكة العربية السعودية، تجلت هذه المقاومة في شكل مضايقات واهتمام غير مرغوب فيه اتجاه الزميلات، وهو ما يمكن فهمه ليس فقط كرد فعل على التهديدات المتصورة لسبل عيش الذكور، بل أيضًا كانعكاس للثقافة الأبوية المتجذرة حيث يتم في كثير من الأحيان ينظر للمرأة بمنظور جنسي. تتماشى النتائج مع بحث والبي الذي يؤكد على الدور الحاسم الذي تلعبه الدولة في تشكيل الظروف التي تتعرض فيها النساء للعنف، بما في ذلك التحرش والاهتمام غير المرغوب فيه في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، يلفت إطار عمل والبي الانتباه أيضًا إلى تقاطع النوع الاجتماعي مع أنظمة القمع الأخرى، مثل الثقافة الأبوية. وتدعم النتائج التي توصلنا إليها هذا المنظور من خلال تسليط الضوء على تأثير الثقافة الأبوية على تجربة النساء في الهشاشة وظهور شكل جديد من أشكال الهشاشة الذاتية نتيجة الصدام بين الحداثة والتقاليد المحافظة. فالثقافة الأبوية، التي تعززها الأعراف والتوقعات المجتمعية، تخلق بيئة تكون فيها النساء عرضة للتحرش ويواجهن تحديات إضافية في الأماكن التي يهيمن عليها الذكور.
تعالج مساهمتنا الثالثة الآثار النظرية لتصور والبي للثقافة الأبوية من خلال تقديم فهم دقيق للتفاعل بين المعايير الدينية والهياكل الأبوية، وتأثيرها المشترك على تجارب الهشاشة القائمة على النوع الاجتماعي. تُسند وجهة النظر الدينية السائدة في السعودية إلى المرأة دور تمثيل وحماية النزاهة الأخلاقية للأمة، وتنشئة جيل مستقبلي متدين، والحفاظ على مفاهيم النقاء القبلي العربي، وترمز إلى التزام الأمة بالإسلام. تماشيًا مع الأبحاث السابقة، والتي تسلط الضوء على كيفية تقاطع الجندر والتدين وعلاقات القوة يشكل اندماج النساء في سوق العمل. تؤكد دراستنا على تأثير التفسيرات والتعاليم الدينية على المعايير المجتمعية وأدوار الجنسين وأنشطة العمل في السعودية. على سبيل المثال، توضح النتائج التي توصلنا إليها كيف عانت النساء من هشاشة ذاتية بسبب المعايير الذكورية التقليدية المهيمنة التي تكرس النظرة المجتمعية التي تعتبر النساء العاملات في أماكن العمل المختلطة بين الجنسين غير محتشمات ومتاحة جنسيًا، وبالتالي تخلق مساحة للتحرش في مكان العمل. وبالمثل، تُشكل التفسيرات والتعاليم الدينية أيضًا المعايير المجتمعية المحيطة بأدوار الرجال بين الجنسين. في هذا السياق، يُنظر إلى الرجال تقليديًا على أنهم المعيلون لأسرهم، كما أن ممارسة المسؤولية المالية للذكور في شكل "المهر" أثناء الزواج متجذرة بعمق في الثقافة العربية. تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الحفاظ على الهياكل الأسرية القائمة والتمسك بأيديولوجية الرجل المعيل السائدة كان متشابكًا بعمق مع شعور الرجال المتزايد بانعدام الأمن الوظيفي. وقد أظهرت دراسات سابقة حول الأيديولوجيات الجندرية للرجال أن الأحكام المؤسسية في سوق العمل تعزز وضع الرجل المعيل وتحافظ عليه. على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن الرجال يعدّلون أيديولوجيتهم الجندرية عند إدراكهم لفائدة وجود معيل آخر للأسرة، إلا أن النتائج التي توصلنا إليها كشفت أن دور الرجل كمعيل للأسرة متجذر بعمق في الهياكل الأسرية الأبوية الأوسع نطاقًا السائدة في المجتمع السعودي، وأن التهديدات لهذا الدور خلقت أشكالًا ذاتية من عدم الاستقرار.
وتماشيًا مع إطار عمل والبي، يؤكد بحثنا على أن النظام الأبوي للدولة، الذي يتسم بدور الدولة في إدامة عدم المساواة بين الجنسين، يمكن أن يستمر على الرغم من تغلب النساء على بعض الحواجز الثقافية. وفي حين أن الأساس النظري لوالبي مفيد في فهم طبيعة النظام الأبوي متعدد الأوجه، فإن دراستنا تسلط الضوء على ديناميكية تزداد أهمية في خطاب عدم المساواة بين الجنسين. فقد وجدنا أن دخول المرأة في المملكة العربية السعودية إلى سوق العمل والتغلب على بعض الحواجز الثقافية لا يرتبط بالضرورة بوعي نسوي قوي. وتشير هذه الملاحظة إلى أن تفكيك النظام الأبوي الحكومي يتطلب أكثر من مجرد معالجة الحواجز الثقافية، بل يتطلب تعزيز الوعي العام والنسوي بين النساء في القوى العاملة. ولذلك، فإن النتائج التي توصلنا إليها توسع بشكل كبير من تركيز والبي على الأبوية الهيكلية والمؤسسية من خلال تسليط الضوء على الدور الحاسم للوكالة الفردية في مواجهة النظم الأبوية. فتمكين المرأة وتفكيك النظام الأبوي لا يعتمدان فقط على التغييرات الهيكلية، بل يتسارعان أيضًا من خلال انخراط المرأة النشط في القيم النسوية. يحث هذا المنظور على إعادة النظر في استراتيجيات المساواة بين الجنسين، ويدعو إلى اتباع نهج مزدوج يدمج بين الإصلاحات الهيكلية والجهود الرامية إلى تنمية العقلية النسوية، لا سيما في سياقات مثل السعودية.
يسلط بحثنا الضوء على ضرورة اقتران معايير التوظيف الجديدة بجهود مدروسة لزيادة الوعي بالحقوق النسوية أو حقوق المرأة بين الموظفات. ويمكن أن يكون استخدام أطر العمل التي تراعي الحساسيات الثقافية، مثل النسوية الإسلامية، مفيدًا في تمكين المرأة السعودية وتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل. ويدرك هذا النهج أن المساواة الشاملة بين الجنسين ليست مجرد مسألة تغيير في السياسات، بل هي أيضًا مسألة تغيير العقليات والأهم من ذلك تمكين النساء أنفسهن من المشاركة بفعالية في تحدي المعايير الأبوية وإعادة تشكيلها. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يسمح هذا النهج بإعادة تفسير الأدوار التقليدية للجنسين، وتحدي المعايير الأبوية مع الحفاظ على جذورها في السياق الثقافي والديني للمملكة العربية السعودية.
المراجع:
Acker, Joan. 2004. "Gender, capitalism and globalization." Critical sociology 1(30):17–41. https://doi.org/10.1163/15691630432298166
Alberti, Gabriella, Ioulia Bessa, Kate Hardy, Vera Trappmann, and Charles Umney. 2018. "In, against and beyond precarity: Work in insecure times." Work, Employment and Society 32(3): 447-457. https://doi.org/10.1177/0950017018762088
Aldossari, Maryam, Sara Chaudhry, Ahu Tatli, and Cathrine Seierstad. 2021. "Catch-22: Token Women Trying to Reconcile Impossible Contradictions between Organisational and Societal Expectations." Work, Employment and Society 09500170211035940.
Aldossari, Maryam, and Thomas Calvard. 2021. "The politics and ethics of resistance, feminism and gender equality in Saudi Arabian organizations." Journal of Business Ethics 1-18. https://doi.org/10.1007/s10551-021-04949-3
Allison, Anne. 2012. "Ordinary refugees: Social precarity and soul in 21st century Japan." Anthropological Quarterly 85(2):345–370. https://www.jstor.org/stable/41857246
Alkhowaiter, Meshal.“Exploring the rising workforce participation among Saudi women”. Middle East Institute, July 9, 2021, https://www.mei.edu/publications/exploring-rising-workforce-participation-among-saudi-women
Al-Rasheed, Madawi. 2013. A Most Masculine State: Gender, Politics and Religion in Saudi Arabia. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139015363
Armstrong, Pat. 1996. “The Feminization of the labour force: Harmonizing down in a global economy”. In Rethinking Restructuring: Gender and Change in Canada, edited by Canada. I. Bakker, 29-54. Toronto: University of Toronto Press.
Ashcraft, Karen Lee. 2005. "Resistance through consent? Occupational identity, organizational form, and the maintenance of masculinity among commercial airline pilots." Management Communication Quarterly 19(1):67-90. https://doi.org/10.1177/0893318905276560
Avishai, Orit. 2008. “Doing religion in a secular world: Women in conservative religions and the question of agency”. Gender & Society 22 (4): 409–33 https://doi.org/10.1177/0891243208321019
Barbieri, Paolo, and Stefani Scherer. 2009. "Labour market flexibilization and its consequences in Italy." European Sociological Review 25(6):677-692. https://doi.org/10.1093/esr/jcp009
Benoit, Cecilia, Michaela Smith, Mikael Jansson, Priscilla Healey, and Douglas Magnuson. 2021. "The relative quality of sex work." Work, Employment and Society 35(2): 239-255. https://doi.org/10.1177/0950017020936872
Bishop, Russell. 2008 "Freeing ourselves from neo-colonial domination in research." In The Landscape of Qualitative Research, edited by Denzin, Norman K., and Yvonna Lincoln, 145–183, Thousand Oak: SAGE.
Casas-Cortés, Maribel. 2017. "A geneology of precarity: A toolbox for rearticulating fragmented social realities in and out of the workplace." In Politics of Precarity, pp. 30-51. Brill.
Charles, Nickie, and Emma James. 2005. "‘He earns the bread and butter and I earn the cream’ job insecurity and the male breadwinner family in South Wales." Work, Employment and Society 19(3):481-502. https://doi.org/10.1177/0950017005055667
Corbin, Juliet, and Anselm Strauss. 2014. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage publications.
During, Simon. 2015. "Choosing precarity." South Asia: Journal of South Asian Studies 38(1):19-38. https://doi.org/10.1080/00856401.2014.975901
Essers, Caroline, and Benschop, Yvonne. 2007. “Enterprising identities: Female entrepreneurs of Moroccan or Turkish origin in the Netherlands”. Organization Studies 28 (1), 49–69. https://doi.org/10.1177/0170840606068256
Eum, Ikran. 2019. “New women for a New Saudi Arabia? Gendered analysis of Saudi Vision 2030 and women’s reform policies”. Asian Women 35(3), 115-133. https://doi.org/10.14431/aw.2019.09.35.3.115
Forde, Chris, and Gary Slater. 2016. "Labour market regulation and the ‘competition state’: An analysis of the implementation of the Agency Working Regulations in the UK." Work, Employment and Society 30(4):590-606. https://doi.org/10.1177/0950017015622917
Frenkel, Michal, and Wasserman, Varda. 2020. “With God on their side: Gender–religiosity intersectionality and women’s workforce integration”. Gender & Society 34(5): 818-843. https://doi.org/10.1177/0891243220949154
Gálvez, Ana, Tirado, Francisco, and Alcaraz, Jose. 2021. “Resisting patriarchal cultures: The case of female Spanish home-based teleworkers”. Work, Employment and Society 35(2): 369-385. https://doi.org/10.1177/0950017020987390
Greer, Ian. 2016. "Welfare reform, precarity and the re-commodification of labour." Work, Employment and Society 30(1):162-173. https://doi.org/10.1177/0950017015572578
Harrison, Patricia, Collins, Helen, and Bahor, Alexandra .2022. “We Don’t Have the Same Opportunities as Others’: Shining Bourdieu’s Lens on UK Roma Migrants’ Precarious (Workers’) Habitus”. Work, Employment and Society 36(2):217-234. https://doi.org/10.1177/09500170209795
Kalleberg, Arne L. 2009. "Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition." American Sociological Review 74(1): 1-22. https://doi.org/10.1177/000312240907400101
Karmowska, Joanna, John Child, and Philip James. 2017. "A contingency analysis of precarious organizational temporariness." British Journal of Management 28(2): 213–230. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12185
Lambert, Rob, and Andrew Herod, eds. 2016. Neoliberal capitalism and precarious work: Ethnographies of accommodation and resistance. Edward Elgar Publishing.
Lee, Ching Kwan, and Yelizavetta Kofman. 2012. "The politics of precarity: views beyond the United States." Work and Occupations 39(4): 388-408. https://doi.org/10.1177/0730888412446710
Le Renard, Amélie. 2014. A society of young women: Opportunities of place, power, and reform in Saudi Arabia. Stanford University Press.
Lorey, Isabell. 2015. State of insecurity: Government of the precarious. London: Verso Books.
Liu, Ye. 2023. “As the two-child policy beckons: Work–family conflicts, gender strategies and self-worth among women from the first one-child generation in contemporary China”. Work, Employment and Society 37(1): 20-38. 1
https://doi.org/10.1177/0950017021101694
McLaughlin, Heather, Christopher Uggen, and Amy Blackstone. 2017. "The economic and career effects of sexual harassment on working women." Gender & Society 31(3): 333-358. https://doi.org/10.1177/0891243217704631
McMunn, Anne, Lauren Bird, Elizabeth Webb, and Amanda Sacker. 2020. "Gender divisions of paid and unpaid work in contemporary UK couples." Work, Employment and Society 34(2):155-173. https://doi.org/10.1177/0950017019862153
Mahmood, Saba. 2011. Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Neilson, Brett, and Ned Rossiter. 2008. "Precarity as a political concept, or, Fordism as exception." Theory, Culture & Society 25(7): 51–72. https://doi.org/10.1177/0263276408097796
Oakley, Ann. 2016. "Interviewing women again: Power, time and the gift." Sociology 50(1):195-213. https://doi.org/10.1177/0038038515580253
O'Keefe, Theresa, and Aline Courtois. 2019. "‘Not one of the family’: Gender and precarious work in the neoliberal university." Gender, Work & Organization 26(4): 463-479. https://doi.org/10.1111/gwao.12346
Pourmehdi, Mansour, and Hadi Al Shahrani. 2021. "The role of social media and network capital in assisting migrants in search of a less precarious existence in Saudi Arabia." Migration and Development 10(3): 388-402. https://doi.org/10.1080/21632324.2019.1654230
Prosser, Thomas. "Dualization or liberalization? Investigating precarious work in eight European countries." Work, Employment and Society 30(6):949-965. https://doi.org/10.1177/0950017015609036
Ridgeway, Cecilia L. 2011. Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World. Oxford: Oxford University Press.
Saudi General Authority for Statistics. 2022. Labor market statistics Q1 2022.
Sian, Suki, Dila Agrizzi, T. Wright, and A. Alsalloom. 2020. "Negotiating constraints in international audit firms in Saudi Arabia: exploring the interaction of gender, politics and religion." Accounting, Organizations and Society 84: 101103. https://doi.org/10.1016/j.aos.2020.101103
Smithson, Janet, Suzan Lewis, Cary Cooper, and Jackie Dyer. 2004. "Flexible working and the gender pay gap in the accountancy profession." Work, Employment and Society 18(1): 115–35. https://doi.org/10.1177/0950017004040765
Syed, Jawad, Faiza Ali, and Sophie Hennekam. 2018. "Gender equality in employment in Saudi Arabia: a relational perspective." Career Development International 23(2): 163-177. DOI 10.1108/CDI-07-2017-0126
Tatli, Ahu, and Mustafa F. Özbilgin. 2012. "An emic approach to intersectional study of diversity at work: A Bourdieuan framing." International Journal of Management Reviews 14(2):180-200. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00326.x
Tariq, Memoona, and Jawad Syed 2018. “An intersectional perspective on Muslim women’s issues and experiences in employment”. Gender, Work & Organization 25 (5): 495–513. https://doi.org/10.1111/gwao.12256
Trappe, Heike, Matthias Pollmann-Schult, and Christian Schmitt. 2015. "The rise and decline of the male breadwinner model: Institutional underpinnings and future expectations." European Sociological Review 31(2):230-242. https://doi.org/10.1093/esr/jcv015
Tlaiss, Hayfaa A., and Mohammed Al Waqfi. 2022. "Human resource managers advancing the careers of women in Saudi Arabia: caught between a rock and a hard place." The International Journal of Human Resource Management 22(9):1812-1847. https://doi.org/10.1080/09585192.2020.1783342
Raz, Aviad , and Gavan Tzruya. 2018. “Doing gender in segregated and assimilative organizations: ultra-orthodox Jewish women in the Israeli high-tech labour market”. Gender, Work & Organization 25 (4): 361–78. https://doi.org/10.1111/gwao.12205
Sutherland Will, Jarrahi, Mohammad Hossein, Dunn, Michael, and Nelson, Beth Nelson. 2020. “Work precarity and gig literacies in online freelancing”. Work, Employment and Society 34(3):457-475. https://doi.org/10.1177/0950017019886511
Van den Brink, Marieke, and Yvonne Benschop. 2018. "Gender interventions in the Dutch police force: resistance as a tool for change?." Journal of Change Management 18(3): 181-197. https://doi.org/10.1080/14697017.2017.1378695
Van Douwen, Nina, Marieke van den Brink, and Yvonne Benschop.2022. "Badass marines: Resistance practices against the introduction of women in the Dutch military." Gender, Work & Organization 29(5): 1443-1462. https://doi.org/10.1111/gwao.12835
Vision 2030. 2016. Vision2030govsa. Available at: https://vision2030.gov.sa/en
Vosko, Leah F. 2000. Temporary work: The gendered rise of a precarious employment relationship. Toronto: University of Toronto Press.
Waite, Louise. 2009. "A place and space for a critical geography of precarity?." Geography Compass 3(1): 412–433. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2008.00184.x
Warren, Tracey, and Clare Lyonette. 2018. "Good, bad and very bad part-time jobs for women? Re-examining the importance of occupational class for job quality since the ‘Great Recession’ in Britain." Work, Employment and Society 32(4): 747–767. https://doi.org/10.1177/0950017018762289
Walby, Sylvia. 1989. “Theorising patriarchy”. Sociology 23(2): 213-234. https://www.jstor.org/stable/42853921
Wong, May ML. 2005. "Subtextual gendering processes: A study of Japanese retail firms in Hong Kong." Human Relations 58(2): 249-276. https://doi.org/10.1177/0018726705052183